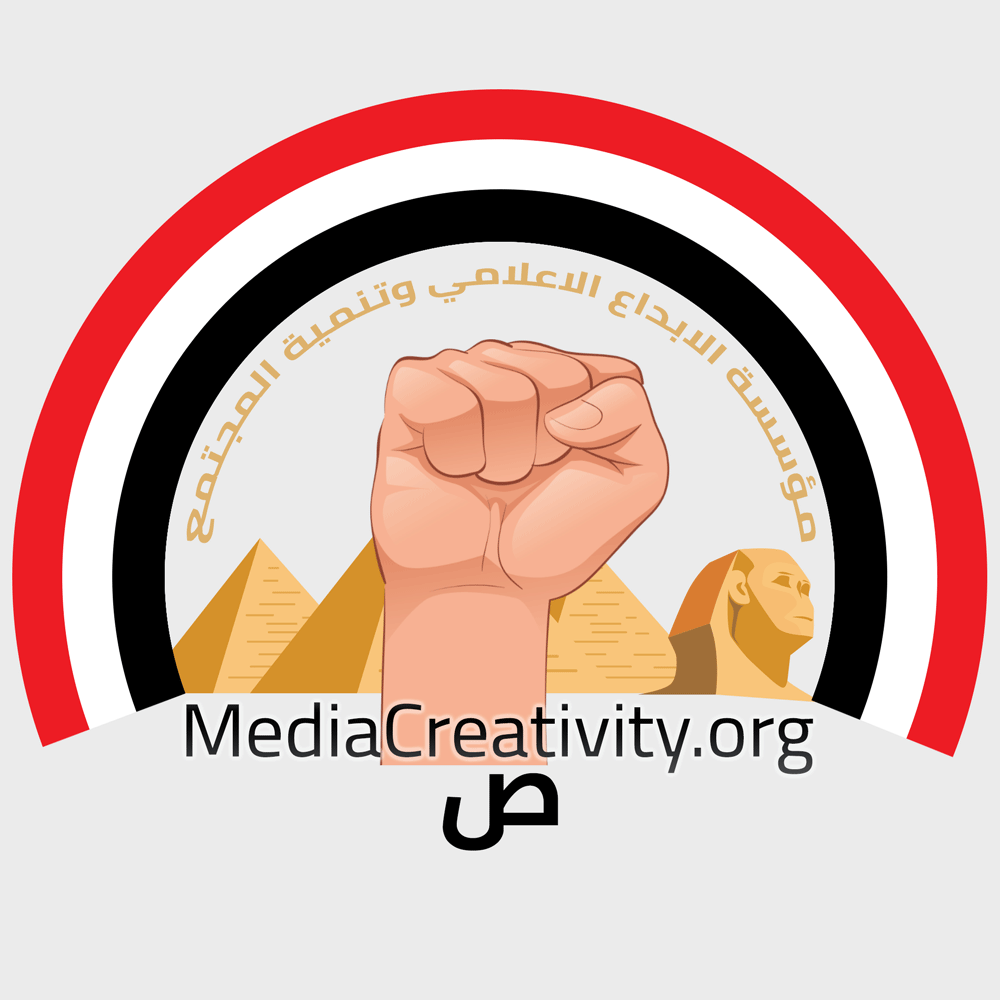د.وليد جاب الله يكتب: تغييب الوعي يأتي نتيجة خلط الأدوار ما بين "الثقافة والتعليم"

هل لنا أن نسأل أنفسنا عن أخر كتاب قرأناه؟، عن أخر إضافة علمية اكتسبناها؟، هل وصل بنا الحال لنسأل عن أخر صحيفة قرأناها؟، لعل كل هذه الأسئلة وغيرها تعبر إجاباتها عن حالة الانهيار الثقافي الذي أصاب المجتمع المصري، حتى وصل بنا الحال إلى عدم القدرة على تشخيص الخلل بانتقادات متكررة لوزارتي التعليم وكيف أن التعليم سيء.
في الوقت الذي تجد فيه الخريجين المصريين من الأطباء والمهندسين وغيرهم، لا يقلون كفاءة بل يتفوقوا على أقرانهم من خريجين أوروبا، إذا اجتمعوا معهم في أعمال مشتركة.
القضية إننا أصبحنا نخلط ما بين التعليم والثقافة، حيث نهتم بالمقررات الدراسية للحصول على أعلى الدرجات متصورين أن مجرد التفوق الدراسي سوف يخلق إنسان مثقف بصورة تلقائية، فكانت النتيجة هي ظهور أجيال من المتعلمين الماهرين في تخصصاتهم دون أي أساس ثقافي أو فهم لطبيعة الأمور الخارجة عن ذلك التخصص، متصورين أن مؤهلهم الدراسي أو مهنتهم البراقة عنوان لثقافتهم وقُدرتهم على تحليل الأمور.
لنصل إلى حقيقة في غاية الغرابة وهي أن ثقافة الكثير من المصريين حالياً تتشكل من خلال طرق جديدة أهمها:
الطريق الأول: هو برامج «التوك شو» التلفزيونية والتي أصبحت نافذة للأخبار والتحليل والفهم حيث يُسلم الشخص عقلة لبرنامج واحد، هو البرنامج الذي يتصادف مع وقت راحته من العمل ويرتاح لشخصيه مقدمه، فيعرف من البرنامج الأخبار وتحليلها وفقاً لرؤية مقدم البرنامج وضيوفه الذين يتحدثون في سياق يعبر عن سياسة هذا البرنامج، ومع تنوع البرامج واستحواذ كل برنامج على جانب من الجمهور، نجد الجميع يدخل في نقاشات الشأن العام من خلال الحجج التي تم شحنها لكل منهم حسب البرنامج الذي يتابعه ويشكل معتقداته الثقافية.
الطريق الثاني: وهو الأخطر يتمثل في مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يتم استدراج الأشخاص لمتابعة صفحات وحسابات معظمها وهمية تُدار من خلال لجان إلكترونية، تُلاحق الشخص بالأخبار الموجهة والتحليلات الجاهزة التي تسبق تفكيره فتسيطر على قناعاته من خلال دمج الحقيقي بالكاذب بدعم من أدوات تكنولوجية تصنع الكثير من الصور والفيديوهات والأدلة المفبركة التي لا ترتب مسؤولية على مصدرها لأنه شخص أو كيان وهمي من الأساس لا يمكن الرجوع علية أو مناقشته في صحة معلوماته.
وهكذا نجد أن بساط الثقافة والقيم المصرية الأصيلة يتراجع، ونستطيع سماع صُراخ يُحمل التعليم المسؤولية رغم نجاح الكثير من الخريجين في أسواق العمل داخل مصر وخارجها، وصُراخ أخر يُحمل الخطاب الديني الرسمي المسؤولية رغم أن الشخصية المصرية العظيمة قديمة وسابقة على ظهور الأديان جميعاً.
كل ذلك يحدث دون أن نسمع نهائياً عن أي انتقاد لوزارة الثقافة أو استنفار لدورها، تلك الوزارة التي نشأت وبدأ كيانها في التبلور بعد قيام ثورة يوليو 1952 تحت أسم وزارة الإرشاد، ثم اقترن معه أسم الثقافة لتكون وزارة الثقافة والإرشاد إلى أن أنتهى بها الحال لمسمى وزارة الثقافة، التي كان تولى الوزير فاروق حسني لمقاليدها عام 1987 علامة فارقة في أنشطتها، حيث حولها من وزارة للثقافة إلى وزارة المثقفين الذين انشغلت معهم الوزارة بمجالات ثقافية بعيدة عن اهتمامات المجتمع، فباستثناء بعض الأعمال ذات التأثير الثقافي المحدود، نجد أنه في الوقت الذي أختفى فيه دور الهيئة العامة لقصور الثقافة وهي المؤسسة الثقافية التي لها فروع تغطي معظم أنحاء الجمهورية فقد انصبت أنشطة الوزارة علي هيئات مركزية تركز خدماتها لسكان القاهرة مثل المجلس الأعلى للثقافة ودار الأوبرا ومراكز السينما والترجمة وأكاديمية الفنون واستحوذ على الإهتمام فاعليات فنون محدودة التأثير لا يهتم بها حتى المثقفين أنفسهم فظهر بينالي الفنون التشكيلية، وسمبوزيون النحت، وترينالي الخزف ومهرجان الرقص المسرحي، ومهرجان الأفلام التسجيلية، وغيرها من الفاعليات التي استنفذت ميزانية الوزارة على أمور ليس لها تأثير في ثقافة المجتمع.
وكان نتاج ذلك حدوث حالة من التراجع الثقافي التي من أهم آثارها ما نشاهده من مظاهر السيطرة الثقافية لأعداء الوطن على عقول قطاع عريض من المواطنين حتى وصل الأمر إلى مشاهدة بعض الأباء تحول أفكار أبنائهم نحو التطرف بسرعة ودون وجود قدرة ثقافية لمراجعتهم عن أفكارهم الهدامة، فانتشرت دائرة التطرف من تطرف ديني لتطرف في دعم اتجاه سياسي، لغيره من أنواع التطرف التي يقف المجتمع عاجزاً عن مواجهة أبسطها وهو التطرف في التشجيع الرياضي، ولم نجد وسط كل ذلك أي انتقاد لدور وزارة الثقافة شبه المنعدم والذي يحتاج لقوة دفع هائلة تحول تلك الوزارة من وزارة للمثقفين إلى وزارة للتثقيف.
لهذا لابد أن ندق جرس الإنذار لغياب دور وزارة الثقافة، والحاجة لأن تخلق مجال لمثقفيها يساعدهم في نشر ثقافتهم على جموع المواطنين من خلال أفكار خارج الصندوق تلائم تطورات العصر الثقافية والتكنولوجية وتدمج الأصالة بالمعاصرة وتعمل على إعادة إحياء قيم الشخصية المصرية الأصيلة، لتستعيد مصر قوتها الناعمة التي هي في أمس الحاجة إليها.




1695076140jpeg)